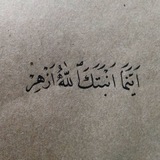👈المعنى الإجمالي :
يوضح هذا الحديث الشريف مراتب الدين، وأنها ثلاثة مراتب، أولها الإسلام الذي يعنى الاستسلام والخضوع والانقياد لله ظاهرًا وباطنًا والتبرؤ من الشرك وأهله، وقد فسره النبي ﷺ بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل، فالإسلام شامل لجميع الواجبات الظاهرة، واقتصر على ذكر بعضها لأنها الأصل التي يبنى عليها، ثانيها الإيمان الذي هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان، وفسره النبي ﷺ بالاعتقادات الباطنة، ثم المرتبة الثالثة والأخيرة وهي الإحسان قبتها وأعظمها، وهو أخص من الإيمان والإسلام ، وقد أشار النبي ﷺ إلى أنه يشتمل على مقامين:
1⃣-أحدهما: مقام المراقبة وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه وإطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله؛ لأن استحضاره ذلك يمنعه من الإلتفات لغير الله.
2⃣-الثاني: مقام المشاهدة وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدته لله بقلبه فيتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان، وهذا هو حقيقة الإحسان ويتفاوت أهله فيه بحسب بصائرهم.
والإحسان يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، ويوجب كذلك النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها.
وعرج على بعض المسائل الغيبية الخاصة بقيام الساعة والتي لا يعلمها إلا الله بذكر بعض العلامات لها، ليكون المسلم على استعداد لها، وخوف من وقوعها دون عمل.
👌ما يؤخذ من الحديث :
1- أن الإسلام والإيمان والإحسان تسمى جميعها دينًا.
2- جواز سؤال العالم ما لا يجهله السائل ليُعلم السامع.
3- أن السؤال الحسن والهادف يسمى علماً وتعليماً، حتى اشتهر قولهم: حسن السؤال نصف العلم.
4- أنه ينبغي على العالم أو المفتي أن لا يتحرج أن يقول: لا أعلم، إذا سئل عما يجهله أو لا يعرفه.
5- تأكد الإيمان باليوم الأخر وما يتعلق به من أمور غيبية لا يعلمها إلا الله.
6- مشروعية رفق العالم بالسائل وتقريبه منه ليتمكن من السؤال غير هائب ولا خائف.
7- أن المتسبب كالمباشر في باب الجنايات؛ حيث إن النبي ﷺ جعل جبريل معلماً، لأنه الذي سأل وكان التعليم بسببه.
يوضح هذا الحديث الشريف مراتب الدين، وأنها ثلاثة مراتب، أولها الإسلام الذي يعنى الاستسلام والخضوع والانقياد لله ظاهرًا وباطنًا والتبرؤ من الشرك وأهله، وقد فسره النبي ﷺ بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل، فالإسلام شامل لجميع الواجبات الظاهرة، واقتصر على ذكر بعضها لأنها الأصل التي يبنى عليها، ثانيها الإيمان الذي هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان، وفسره النبي ﷺ بالاعتقادات الباطنة، ثم المرتبة الثالثة والأخيرة وهي الإحسان قبتها وأعظمها، وهو أخص من الإيمان والإسلام ، وقد أشار النبي ﷺ إلى أنه يشتمل على مقامين:
1⃣-أحدهما: مقام المراقبة وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه وإطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله؛ لأن استحضاره ذلك يمنعه من الإلتفات لغير الله.
2⃣-الثاني: مقام المشاهدة وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدته لله بقلبه فيتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان، وهذا هو حقيقة الإحسان ويتفاوت أهله فيه بحسب بصائرهم.
والإحسان يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، ويوجب كذلك النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها.
وعرج على بعض المسائل الغيبية الخاصة بقيام الساعة والتي لا يعلمها إلا الله بذكر بعض العلامات لها، ليكون المسلم على استعداد لها، وخوف من وقوعها دون عمل.
👌ما يؤخذ من الحديث :
1- أن الإسلام والإيمان والإحسان تسمى جميعها دينًا.
2- جواز سؤال العالم ما لا يجهله السائل ليُعلم السامع.
3- أن السؤال الحسن والهادف يسمى علماً وتعليماً، حتى اشتهر قولهم: حسن السؤال نصف العلم.
4- أنه ينبغي على العالم أو المفتي أن لا يتحرج أن يقول: لا أعلم، إذا سئل عما يجهله أو لا يعرفه.
5- تأكد الإيمان باليوم الأخر وما يتعلق به من أمور غيبية لا يعلمها إلا الله.
6- مشروعية رفق العالم بالسائل وتقريبه منه ليتمكن من السؤال غير هائب ولا خائف.
7- أن المتسبب كالمباشر في باب الجنايات؛ حيث إن النبي ﷺ جعل جبريل معلماً، لأنه الذي سأل وكان التعليم بسببه.
#شرح_اللؤلؤ_والمرجان_فيما_اتفق_عليه_الشيخان
#الدرس_السادس
#كتاب_الإيمان
👈 الوجيز في 👇
📓 شرح الحديث الصحيح 📓
【باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام】
🔸 شرح الحديث السادس 👇
(6)- عن طلحَةَ بن عُبَيْد الله قال: جاءَ رجلٌ إِلى رسولِ الله ﷺ مِن أهل نجْدٍ ثائرُ الرأسِ يُسْمَعُ دوِيُّ صوتِهِ ولا يُفْقَهُ ما يقول حتى دنا، فإِذا هو "يسأَل عن الإسلام؛ فقال رسول الله ﷺ : خمسُ صلواتٍ في اليومِ والليلةِ، فقال: هل عليّ غيرُها؟ قال: لا، إِلا أَنْ تَطَوَّعَ ، قال رسول الله ﷺ : وصيامُ رمضانَ قال: هل عليّ غيره؟ قال: لا، إِلا أَن تَطَوَّعَ قال: وذكر له رسول الله ﷺ الزكاةَ، قال: هل عليَّ غيرُها؟ قال: لا، إِلا أَنْ تَطَوَّعَ، قال: فأَدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أَنْقصُ، قال رسول الله ﷺ: "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ".
▪️سبب ورود الحديث :
أن رجلاً من أهل نجد جاء إلى رسول الله ﷺ يسأله عن الإسلام.
👈مناسبة الحديث :
يشتمل الحديث على بعض أركان الإسلام والتي منها إقامة الصلاة.
🔸التعريف بالراوي :
طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب القرشي التيمي، أبو محمد المدني، وأمه: الصعبة بنت الحضرمي أخت العلاء بن الحضرمي، وسماه رسول الله ﷺ : طلحة الخير، وطلحة الجود، وطلحة الفياض، وتُوفي سنة ستة وثلاثين للهجرة.
↩️ معاني المفردات :
قوله: "من أهل نجد": النجد ما ارتفع من الأرض، وصحراء نجد معروفة شرق الحجاز، سميت نجدًا لارتفاعها.
قوله: "ثائر الرأس": أي متفرق شعر الرأس، وهذا شأن من ترك الرفاهية وسافر في الصحراء.
قوله: "دوي الصوت": شدته وارتفاعه وتكرره ومنه دوي النحل.
قوله: "خمس صلوات في اليوم والليلة": ظاهره عدم التطابق بين السؤال والجواب، ولهذا قيل: إن الرجل كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأنه إنما كان يسأل عن شرائع الإسلام وأموره، فقيل له: أمور الإسلام خمس صلوات ... وكذا وكذا.
قوله: "لا، إلا أن تطَّوع": لا يجب عليك شيء غيرهن، لكن يستحب لك التطوع.
قوله: "أفلح إن صدق": الفلاح الظفر وإدراك البغية.
👈المعنى الإجمالي :
بعد أن هاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة أخذ نور الإسلام ينتشر في صحراء نجد من أفواه المؤمنين، وأخذ شعاعه يشق طريقه إلى صدور أهل البوادي فتطمئن له قلوبهم ويسلمون، ثم يدفعهم حب الاستطلاع والرغبة في الاستيثاق مما وصلهم من التعاليم، والحرص على الاستزادة من أمور الدين، كل ذلك كان يدفع الكثير منهم إلى القدوم إلى المدينة للقاء رسول الله ﷺ.
ومن الوافدين عليه رجل من أهل البادية، قدم من السفر، أشعث أغبر، سأل عن المسجد النبوي فقصده، فرأى فيه جماعة من الناس يجلسون، فنادى من بعيد، أين محمد؟ لأسأله عن شرائع الإسلام وأموره؟
فجاء الرجل النبي ﷺ فجلس، ثم قال: يا محمد، لقد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأحب أن أعلم منك ما يجب علي، ماذا علي من الصلوات؟ فقال رسول الله ﷺ: خمس صلوات في كل يوم وليلة، فسأل: هل علي صلاة غيرها؟ فأجابه النبي ﷺ: ليس عليك غيرها، لكن لك أن تتطوع بما تشاء من صلاة، قال الرجل: فماذا علي من صوم؟ قال ﷺ: صيام شهر رمضان من كل عام، قال الرجل: هل علي من صوم غيره؟ قال النبي ﷺ: ليس عليك صيام غيره، لكن لك أن تتطوع، قال الرجل: فماذا علي من زكاة؟ فبين له ﷺ ما يجب عليه من زكاة، فقال الرجل: هل علي من زكاة غيرها؟ فقال له النبي ﷺ: ليس عليك زكاة غيرها، لكن لك أن تتطوع بما تشاء من صدقات، فلما انتهي من سؤاله أدبر وهو يقول: والله لا أزيد على ما وجب علي شيئًا ولا أنقص، فقال رسول الله ﷺ لأصحابه: إن صدق هذا الرجل فيما يقول، أفلح ونجا وفاز.
👌ما يؤخذ من الحديث :
1– أن الصلاة من أركان الإسلام وأنها خمس صلوات في اليوم والليلة.
2– أن الصوم ركن من أركان الإسلام وهو شهر في كل سنة.
3– أن الزكاة أيضًا ركن من أركان الإسلام.
4- جواز الحلف بغير استحلاف ولا ضرورة.
5- تعليق الفلاح على الصدق في التزام العمل وعدم النقص، ومفهومه أنه من قصر لم يفلح.
#الدرس_السادس
#كتاب_الإيمان
👈 الوجيز في 👇
📓 شرح الحديث الصحيح 📓
【باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام】
🔸 شرح الحديث السادس 👇
(6)- عن طلحَةَ بن عُبَيْد الله قال: جاءَ رجلٌ إِلى رسولِ الله ﷺ مِن أهل نجْدٍ ثائرُ الرأسِ يُسْمَعُ دوِيُّ صوتِهِ ولا يُفْقَهُ ما يقول حتى دنا، فإِذا هو "يسأَل عن الإسلام؛ فقال رسول الله ﷺ : خمسُ صلواتٍ في اليومِ والليلةِ، فقال: هل عليّ غيرُها؟ قال: لا، إِلا أَنْ تَطَوَّعَ ، قال رسول الله ﷺ : وصيامُ رمضانَ قال: هل عليّ غيره؟ قال: لا، إِلا أَن تَطَوَّعَ قال: وذكر له رسول الله ﷺ الزكاةَ، قال: هل عليَّ غيرُها؟ قال: لا، إِلا أَنْ تَطَوَّعَ، قال: فأَدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أَنْقصُ، قال رسول الله ﷺ: "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ".
▪️سبب ورود الحديث :
أن رجلاً من أهل نجد جاء إلى رسول الله ﷺ يسأله عن الإسلام.
👈مناسبة الحديث :
يشتمل الحديث على بعض أركان الإسلام والتي منها إقامة الصلاة.
🔸التعريف بالراوي :
طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب القرشي التيمي، أبو محمد المدني، وأمه: الصعبة بنت الحضرمي أخت العلاء بن الحضرمي، وسماه رسول الله ﷺ : طلحة الخير، وطلحة الجود، وطلحة الفياض، وتُوفي سنة ستة وثلاثين للهجرة.
↩️ معاني المفردات :
قوله: "من أهل نجد": النجد ما ارتفع من الأرض، وصحراء نجد معروفة شرق الحجاز، سميت نجدًا لارتفاعها.
قوله: "ثائر الرأس": أي متفرق شعر الرأس، وهذا شأن من ترك الرفاهية وسافر في الصحراء.
قوله: "دوي الصوت": شدته وارتفاعه وتكرره ومنه دوي النحل.
قوله: "خمس صلوات في اليوم والليلة": ظاهره عدم التطابق بين السؤال والجواب، ولهذا قيل: إن الرجل كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأنه إنما كان يسأل عن شرائع الإسلام وأموره، فقيل له: أمور الإسلام خمس صلوات ... وكذا وكذا.
قوله: "لا، إلا أن تطَّوع": لا يجب عليك شيء غيرهن، لكن يستحب لك التطوع.
قوله: "أفلح إن صدق": الفلاح الظفر وإدراك البغية.
👈المعنى الإجمالي :
بعد أن هاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة أخذ نور الإسلام ينتشر في صحراء نجد من أفواه المؤمنين، وأخذ شعاعه يشق طريقه إلى صدور أهل البوادي فتطمئن له قلوبهم ويسلمون، ثم يدفعهم حب الاستطلاع والرغبة في الاستيثاق مما وصلهم من التعاليم، والحرص على الاستزادة من أمور الدين، كل ذلك كان يدفع الكثير منهم إلى القدوم إلى المدينة للقاء رسول الله ﷺ.
ومن الوافدين عليه رجل من أهل البادية، قدم من السفر، أشعث أغبر، سأل عن المسجد النبوي فقصده، فرأى فيه جماعة من الناس يجلسون، فنادى من بعيد، أين محمد؟ لأسأله عن شرائع الإسلام وأموره؟
فجاء الرجل النبي ﷺ فجلس، ثم قال: يا محمد، لقد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأحب أن أعلم منك ما يجب علي، ماذا علي من الصلوات؟ فقال رسول الله ﷺ: خمس صلوات في كل يوم وليلة، فسأل: هل علي صلاة غيرها؟ فأجابه النبي ﷺ: ليس عليك غيرها، لكن لك أن تتطوع بما تشاء من صلاة، قال الرجل: فماذا علي من صوم؟ قال ﷺ: صيام شهر رمضان من كل عام، قال الرجل: هل علي من صوم غيره؟ قال النبي ﷺ: ليس عليك صيام غيره، لكن لك أن تتطوع، قال الرجل: فماذا علي من زكاة؟ فبين له ﷺ ما يجب عليه من زكاة، فقال الرجل: هل علي من زكاة غيرها؟ فقال له النبي ﷺ: ليس عليك زكاة غيرها، لكن لك أن تتطوع بما تشاء من صدقات، فلما انتهي من سؤاله أدبر وهو يقول: والله لا أزيد على ما وجب علي شيئًا ولا أنقص، فقال رسول الله ﷺ لأصحابه: إن صدق هذا الرجل فيما يقول، أفلح ونجا وفاز.
👌ما يؤخذ من الحديث :
1– أن الصلاة من أركان الإسلام وأنها خمس صلوات في اليوم والليلة.
2– أن الصوم ركن من أركان الإسلام وهو شهر في كل سنة.
3– أن الزكاة أيضًا ركن من أركان الإسلام.
4- جواز الحلف بغير استحلاف ولا ضرورة.
5- تعليق الفلاح على الصدق في التزام العمل وعدم النقص، ومفهومه أنه من قصر لم يفلح.
#شرح_اللؤلؤ_والمرجان_فيما_اتفق_عليه_الشيخان
#الدرس_السابع
#كتاب_الإيمان
👈 الوجيز في 👇
📓 شرح الحديث الصحيح 📓
【باب: بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة】
🔸 شرح الحديث السابع 👇
(7)- عن أبي أيوبَ الأَنصاريّ رضي الله عنه: أَنَّ رجلاً قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يُدْخِلُني الجنة، فقال القوم: مَا لَهُ؟ مَا لَه؟ فقال رسول الله ﷺ: "أَرَبٌ مَالَهُ"، فقال النبيُّ ﷺ: "تعبُدُ اللهَ لا تُشْرِكُ بهِ شيئًا، وتُقيمُ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِي الزكاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ"، ذرْها، قَال: كأنّه كانَ عَلى رَاحِلَتِهِ.
👈مناسبة الحديث :
أن الحديث ذكر طرفًا من أركان الإسلام والإيمان، والتي بها يدخل المرء الجنة وينجو من النار.
🔸التعريف بالراوي :
خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف ويقال: ابن عمرو بن عبد عوف بن غنم ويقال: ابن عبد عوف بن جشم بن غنم بن مالك بن النجار، أبو أيوب الأنصاري الخزرجى، وأمه: هند بنت سعد بن كعب بن عمرو بن امرئ القيس، صاحب الرحل والمتاع في الهجرة، وتُوفي سنة خمسين للهجرة.
↩️ معاني المفردات :
قوله: "ما له؟ ما له؟": كلمة "ما" للإستفهام، والتكرار للتأكيد، ويجوز أن تكون بمعنى: أي شيء جرى له.
قوله: "أَرَبٌ مَالَهُ": أي حاجة، وقيل: له حاجة مهمة مفيدة جاءت به؛ لأنه قد علم بالسؤال أن له حاجة.
قوله : "تعبد الله": توحده، وفسره بقوله: "ولا تشرك به شيئًا".
قوله: "وتقيم الصلاة": إدامتها والمحافظة عليها، وقيل: أدائها على وجهها.
قوله: "وتصل الرحم": رحم الإنسان قرابته، وصلتهم مواساتهم والإحسان إليهم، قال الإمام النووي: معناه أن تحسن إلى أقاربك ذوي رحمك بما تيسر على حسب حالك وحالهم من إنفاق أو سلام أو زيارة أو طاعة أو غير ذلك، وخص هذه الخصلة من بين خصال الخير نظرًا إلى حال السائل كأنه كان لا يصل رحمه فأمره به؛ لأنه المهم بالنسبة إليه.
قوله: "ذرها": أي اتركها يعني الناقة، التي كان النبي ﷺ يركبها.
👈المعنى الإجمالي :
يخبر أبو أيوب عن رجل ولم يسمه، أنه سأل رسول الله ﷺ عن عمل يدخل به الجنة، فتعجب القوم منه ومن فعله، فبين لهم النبي ﷺ وأجابه بما يناسبه، فقال: تعبد الله ثم فسرها بقوله: لا تشرك به شيئًا، وأرشده إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصلة الأرحام، وكان الرجل ممسكًا بزمام راحلة النبي ﷺ، فقال له: اتركها تسير.
وهكذا ترى أن النبي ﷺ أرشده إلى أقصر وأقرب طريق موصلة إلى الجنة من خلال الأسس والركائز والدعائم التي بينها له ودله عليها، فالجواب للرجل ما هو في الحقيقة إلا خطاب لمجموع الأمة وليس خاص بهذا الرجل، فمن أراد أعمالاً توصله إلى الجنة فليلزم هذه الأوامر والإرشادات.
👌ما يؤخذ من الحديث :
1– حلم النبي ﷺ وسعة صدره وحسن معاملته للجاهلين.
2– عظيم شأن التوحيد، لذا صدر الأعمال الموصلة إلى الجنة به.
3– إشعار المسيء بإساءته رغم العفو عنه وعدم مؤاخذته تقديرًا لعذره، فقد أمر ﷺ الأعرابي بترك الناقة إشعارًا له بأنه ما كان ينبغي أن يقع منه ذلك.
4- غلظة وجفاء الأعراب في المعاملة حتى معه ﷺ.
#الدرس_السابع
#كتاب_الإيمان
👈 الوجيز في 👇
📓 شرح الحديث الصحيح 📓
【باب: بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة】
🔸 شرح الحديث السابع 👇
(7)- عن أبي أيوبَ الأَنصاريّ رضي الله عنه: أَنَّ رجلاً قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يُدْخِلُني الجنة، فقال القوم: مَا لَهُ؟ مَا لَه؟ فقال رسول الله ﷺ: "أَرَبٌ مَالَهُ"، فقال النبيُّ ﷺ: "تعبُدُ اللهَ لا تُشْرِكُ بهِ شيئًا، وتُقيمُ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِي الزكاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ"، ذرْها، قَال: كأنّه كانَ عَلى رَاحِلَتِهِ.
👈مناسبة الحديث :
أن الحديث ذكر طرفًا من أركان الإسلام والإيمان، والتي بها يدخل المرء الجنة وينجو من النار.
🔸التعريف بالراوي :
خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف ويقال: ابن عمرو بن عبد عوف بن غنم ويقال: ابن عبد عوف بن جشم بن غنم بن مالك بن النجار، أبو أيوب الأنصاري الخزرجى، وأمه: هند بنت سعد بن كعب بن عمرو بن امرئ القيس، صاحب الرحل والمتاع في الهجرة، وتُوفي سنة خمسين للهجرة.
↩️ معاني المفردات :
قوله: "ما له؟ ما له؟": كلمة "ما" للإستفهام، والتكرار للتأكيد، ويجوز أن تكون بمعنى: أي شيء جرى له.
قوله: "أَرَبٌ مَالَهُ": أي حاجة، وقيل: له حاجة مهمة مفيدة جاءت به؛ لأنه قد علم بالسؤال أن له حاجة.
قوله : "تعبد الله": توحده، وفسره بقوله: "ولا تشرك به شيئًا".
قوله: "وتقيم الصلاة": إدامتها والمحافظة عليها، وقيل: أدائها على وجهها.
قوله: "وتصل الرحم": رحم الإنسان قرابته، وصلتهم مواساتهم والإحسان إليهم، قال الإمام النووي: معناه أن تحسن إلى أقاربك ذوي رحمك بما تيسر على حسب حالك وحالهم من إنفاق أو سلام أو زيارة أو طاعة أو غير ذلك، وخص هذه الخصلة من بين خصال الخير نظرًا إلى حال السائل كأنه كان لا يصل رحمه فأمره به؛ لأنه المهم بالنسبة إليه.
قوله: "ذرها": أي اتركها يعني الناقة، التي كان النبي ﷺ يركبها.
👈المعنى الإجمالي :
يخبر أبو أيوب عن رجل ولم يسمه، أنه سأل رسول الله ﷺ عن عمل يدخل به الجنة، فتعجب القوم منه ومن فعله، فبين لهم النبي ﷺ وأجابه بما يناسبه، فقال: تعبد الله ثم فسرها بقوله: لا تشرك به شيئًا، وأرشده إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصلة الأرحام، وكان الرجل ممسكًا بزمام راحلة النبي ﷺ، فقال له: اتركها تسير.
وهكذا ترى أن النبي ﷺ أرشده إلى أقصر وأقرب طريق موصلة إلى الجنة من خلال الأسس والركائز والدعائم التي بينها له ودله عليها، فالجواب للرجل ما هو في الحقيقة إلا خطاب لمجموع الأمة وليس خاص بهذا الرجل، فمن أراد أعمالاً توصله إلى الجنة فليلزم هذه الأوامر والإرشادات.
👌ما يؤخذ من الحديث :
1– حلم النبي ﷺ وسعة صدره وحسن معاملته للجاهلين.
2– عظيم شأن التوحيد، لذا صدر الأعمال الموصلة إلى الجنة به.
3– إشعار المسيء بإساءته رغم العفو عنه وعدم مؤاخذته تقديرًا لعذره، فقد أمر ﷺ الأعرابي بترك الناقة إشعارًا له بأنه ما كان ينبغي أن يقع منه ذلك.
4- غلظة وجفاء الأعراب في المعاملة حتى معه ﷺ.
#شرح_اللؤلؤ_والمرجان_فيما_اتفق_عليه_الشيخان
#الدرس_الثامن
#كتاب_الإيمان
👈 الوجيز في 👇
📓 شرح الحديث الصحيح 📓
【باب: بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة】
🔸 شرح الحديث الثامن 👇
(8)- عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : أَنَّ أَعْرابِيًّا أَتَى النبي ﷺ فَقالَ: "دُلَّني عَلى عَمَلٍ إِذا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الجنة، قال: "تَعْبُدُ اللهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقيمُ الصَّلاةَ المكتوبةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ المفروضَة، وَتَصُومُ رمضانَ"، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا أَزِيدُ عَلى هذا، فَلَمّا وَلّى، قال النبي ﷺ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أهل الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلى هَذا".
👈مناسبة الحديث :
الحديث فيه بعض أركان الإيمان والإسلام التي تدخل من أتى بها الجنة.
🔸التعريف بالراوي :
أبو هريرة الدوسي اليماني، عبد الرحمن بن صخر، أسلم في العام السابع، ولقب بأبي هريرة؛ لأنه كان يحمل هرًا في كمه، من أوعية العلم، وهو أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية عن رسول الله ﷺ للحديث، وتُوفي رضي الله عنه سنة سبع وخمسين للهجرة.
↩️ معاني المفردات :
قوله: "أن أعرابيًا": قيل هو سعد بن الأخرم، وقيل: ابن المنتفق.
قوله: "على عمل": التنكير فيه للتفخيم أو التنويع، أي: عمل عظيم أو معتبر في الشرع.
قوله: "وتقيم الصلاة المكتوبة": إقامة الصلاة المفروضة، وقد قيل: إن تقييد الصلاة بالمكتوبة لإتباع القرآن في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [سورة النساء: ١٠٣].
قوله: "وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ المفروضَة": إعطاء الزكاة، وتقييد الزكاة بالمفروضة للاحتراز من صدقة التطوع.
قوله: "وتصوم رمضان": صيام شهر رمضان من كل عام.
قوله: "والذي نفسي بيده": أي أقسم بالله الذي حياتي بأمره.
قوله: "لا أزيد على هذا": عن الفرائض أو أكتفي بها عن النوافل، أو يكون المراد: لا أزيد على ما سمعت منك في أدائي لقومي؛ لأنه كان وافدهم إلى رسول الله.
قوله: "فلما ولى": أدبر.
قوله: "من سره": أحب.
👈المعنى الإجمالي :
يوضح النبي ﷺ في هذا الحديث أهم الأعمال التي تدخل الجنة، فصدر النبي الحديث بالتوحيد والبعد عن الشرك؛ لأنه السيئة التي تمحق كل حسنة، وثنى بعد ذلك بذكر طرفًا من أركان الإسلام وعلى رأسها الصلوات الخمس، والزكاة المفروضة المحددة المأخوذة من الأغنياء والمعطاة للفقراء، وصوم رمضان، ولم يذكر الحج وهو من الأركان؛ لأنه لم يكن فرض بعد. فلما أعلم النبي ﷺ الرجل هذه الأعمال، أقسم الرجل ألا يزيد عليها إما في العمل أو في التبليغ، فقال النبي ﷺ لأصحابه أن هذا من أهل الجنة؛ لأن هذه الأعمال لا يباشرها إلا أهل الجنة.
👌 ما يؤخذ من الحديث :
1- تخصيص بعض الأعمال بالحض عليها حسب حال المخاطب.
2- أن أحاديث خصال الإيمان تتفاوت زيادة ونقصانًا وإثباتًا وحذفًا.
3- مشروعية البشارة والتبشير للمؤمن.
4- سؤال من لا يعلم من يعلم عن العمل الذي يكون سببًا لدخول الجنة.
⏪ فائدة متممة :
المبشرون بالجنة معدودون بالعشرة، وبهذا يزاد عليهم؛ لأنه ﷺ نص عليه أنه من أهل الجنة.
وأجيب: بأن التنصيص على العدد لا ينافي الزيادة، وقد ورد أيضًا في حق كثير مثل ذلك، كما قال ﷺ في الحسن والحسين وأزواجه ﷺ، وقيل: العشرة بشروا بالجنة دفعة واحدة فلاينافي المتفرق.
#الدرس_الثامن
#كتاب_الإيمان
👈 الوجيز في 👇
📓 شرح الحديث الصحيح 📓
【باب: بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة】
🔸 شرح الحديث الثامن 👇
(8)- عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : أَنَّ أَعْرابِيًّا أَتَى النبي ﷺ فَقالَ: "دُلَّني عَلى عَمَلٍ إِذا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الجنة، قال: "تَعْبُدُ اللهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقيمُ الصَّلاةَ المكتوبةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ المفروضَة، وَتَصُومُ رمضانَ"، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا أَزِيدُ عَلى هذا، فَلَمّا وَلّى، قال النبي ﷺ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أهل الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلى هَذا".
👈مناسبة الحديث :
الحديث فيه بعض أركان الإيمان والإسلام التي تدخل من أتى بها الجنة.
🔸التعريف بالراوي :
أبو هريرة الدوسي اليماني، عبد الرحمن بن صخر، أسلم في العام السابع، ولقب بأبي هريرة؛ لأنه كان يحمل هرًا في كمه، من أوعية العلم، وهو أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية عن رسول الله ﷺ للحديث، وتُوفي رضي الله عنه سنة سبع وخمسين للهجرة.
↩️ معاني المفردات :
قوله: "أن أعرابيًا": قيل هو سعد بن الأخرم، وقيل: ابن المنتفق.
قوله: "على عمل": التنكير فيه للتفخيم أو التنويع، أي: عمل عظيم أو معتبر في الشرع.
قوله: "وتقيم الصلاة المكتوبة": إقامة الصلاة المفروضة، وقد قيل: إن تقييد الصلاة بالمكتوبة لإتباع القرآن في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [سورة النساء: ١٠٣].
قوله: "وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ المفروضَة": إعطاء الزكاة، وتقييد الزكاة بالمفروضة للاحتراز من صدقة التطوع.
قوله: "وتصوم رمضان": صيام شهر رمضان من كل عام.
قوله: "والذي نفسي بيده": أي أقسم بالله الذي حياتي بأمره.
قوله: "لا أزيد على هذا": عن الفرائض أو أكتفي بها عن النوافل، أو يكون المراد: لا أزيد على ما سمعت منك في أدائي لقومي؛ لأنه كان وافدهم إلى رسول الله.
قوله: "فلما ولى": أدبر.
قوله: "من سره": أحب.
👈المعنى الإجمالي :
يوضح النبي ﷺ في هذا الحديث أهم الأعمال التي تدخل الجنة، فصدر النبي الحديث بالتوحيد والبعد عن الشرك؛ لأنه السيئة التي تمحق كل حسنة، وثنى بعد ذلك بذكر طرفًا من أركان الإسلام وعلى رأسها الصلوات الخمس، والزكاة المفروضة المحددة المأخوذة من الأغنياء والمعطاة للفقراء، وصوم رمضان، ولم يذكر الحج وهو من الأركان؛ لأنه لم يكن فرض بعد. فلما أعلم النبي ﷺ الرجل هذه الأعمال، أقسم الرجل ألا يزيد عليها إما في العمل أو في التبليغ، فقال النبي ﷺ لأصحابه أن هذا من أهل الجنة؛ لأن هذه الأعمال لا يباشرها إلا أهل الجنة.
👌 ما يؤخذ من الحديث :
1- تخصيص بعض الأعمال بالحض عليها حسب حال المخاطب.
2- أن أحاديث خصال الإيمان تتفاوت زيادة ونقصانًا وإثباتًا وحذفًا.
3- مشروعية البشارة والتبشير للمؤمن.
4- سؤال من لا يعلم من يعلم عن العمل الذي يكون سببًا لدخول الجنة.
⏪ فائدة متممة :
المبشرون بالجنة معدودون بالعشرة، وبهذا يزاد عليهم؛ لأنه ﷺ نص عليه أنه من أهل الجنة.
وأجيب: بأن التنصيص على العدد لا ينافي الزيادة، وقد ورد أيضًا في حق كثير مثل ذلك، كما قال ﷺ في الحسن والحسين وأزواجه ﷺ، وقيل: العشرة بشروا بالجنة دفعة واحدة فلاينافي المتفرق.
#شرح_اللؤلؤ_والمرجان_فيما_اتفق_عليه_الشيخان
#الدرس_التاسع
#كتاب_الإيمان
👈 الوجيز في 👇
📓 شرح الحديث الصحيح 📓
【باب قول النبي ﷺ بُني الإسلام على خمس】
🔸 شرح الحديث التاسع 👇
(9)- عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "بُنِيَ الإِسْلامُ عَلى خَمْسٍ: شَهادَةِ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقامِ الصَّلاةِ، وَإِيتاءَ الزَّكاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ".
🔸 منزلة الحديث :
يقول الإمام النووي: "ثم إن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده وقد جمع أركانه".
👈مناسبة الحديث للباب :
يشير الحديث إلى أن دعائم وأسس وأركان الإسلام خمسة يقوم عليها.
🔸التعريف بالراوي :
عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عبد الرحمن المكي، وهو شقيق حفصة أم المؤمنين، أمهما: زينب بنت مظعون، أخت عثمان بن مظعون، أسلم بمكة وهو صغير وهاجر مع أبيه، ولم يشهد غزوة بدر ولا أحد لصغر سنه، وشارك في الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة.
وهو أحد العبادلة الأربعة مع عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير، غير أن الجوهري أثبت عبد الله بن مسعود وأخرجه، وهو من المكثرين في الرواية عن النبي ﷺ، حيث إنه روى رضي الله عنه ألف وستمائة وثلاثون حديثًا، اتفق الشيخان منها على مائة وسبعين، وانفرد البخاري بثمانين، ومسلم بإحدى وثلاثين. كان عالمًا زاهدًا عابدًا ورعًا. تُوفي بمكة سنة ثلاث وسبعين عن أربع وثمانين.
↩️ معاني المفردات :
قوله: "بُنِيَ الإِسْلامُ": أُسس الإسلام.
قوله: "شَهادَةِ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ": الشهادة هي الإخبار عن علم واعتقاد، والمعنى أن يقر العبد عن اعتقاد جازم أنه لا إله معبود بحق إلا الله سبحانه، ولا تتحقق الشهادة إلا بركنين: نفى عما سوى الله، وإثباتها له وحده لا شريك له.
قوله: "وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ": تقتضي الإقرار بأن محمدًا عبدُ لله ورسوله أُرسل لتبليغ دينه وهداية الخلق.
قوله: "وإقام الصلاة: أداؤها تامة بشروطها وأركانها والمحافظة على أوقاتها ومراعاة سننها وآدابها؛ لذا لم يقل أداء الصلاة؛ لأنه ليس مقصود الشارع فعلها فحسب، وإنما مقصوده الإتيان بها كاملة.
قوله: "وإيتاء الزكاة": أي إعطاء الزكاة ودفعها للأصناف التي حددها الشارع وفقًا لأحكامها ومقاديرها الشرعية. واشتقاقها من الزكاء أي النماء لأنها بركة للمال.
قوله: "وحج البيت": يعني القصد إلى بيت الله العتيق لأداء مناسك مخصوصة بنية خالصة لله تعالى.
قوله: "وصوم رمضان": الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية خالصة لله تعالى.
👈المعنى الإجمالي :
يشبه النبي ﷺ الإسلام بالبنيان الذي يقوم على أسس هذه الأسس هي الأركان الخمس التي يقوم عليها صرح الإسلام، فكما أن البنيان لا يثبت بدونها، فكذلك الإسلام، مع أن بقية خصال الإسلام تتمة للبنيان، فإذا فقد منها شيء نقص البنيان وهو قائم لا ينتقض بنقص ذلك بخلاف نقص هذه الدعائم الخمس، فإن الإسلام يزول بزوالها جميعا بغير إشكال، وكذلك يزول بفقد الشهادتين، فمن التزم بهذه الأركان الخمسة صار مسلمًا، ومن تركها جميعًا أو جحد شيئًا منها كفر.
فأول هذه الأركان وأعظمها كلمة التوحيد بشقيها، فهي المفتاح الذي يدخل به العبد إلى رياض الدين، ويكون به مستحقاً لجنات النعيم، فشقها الأول: "أشهد أن لا إله إلا الله" يعنى أن تشهد بلسانك مقرًا بقلبك بأنه لا يستحق أحد العبادة إلا الله، فلا نعبد إلا الله، ولا نرجو غيره، ولا نتوكل إلا عليه، وأما شقها الثاني: "أشهد أن محمدًا رسول الله" فتعني أنه لا متبوع بحق إلا رسول الله.
والنبي ﷺ جعل الشهادتين ركنًا واحدًا إشارة إلى أن العبادة لا تتم إلا بأمرين :
١) الأول: الإخلاص، وهو ما يحويه الشق الأول منها،
٢) والثاني: المتابعة، وهو مفهوم الشق الثاني.
الركن الثاني هو إقامة الصلاة المفروضة على الوجه الصحيح؛ لأنها صلة بين العبد وربه، ومناجاة لخالقه سبحانه، وهي الزاد الروحي الذي يطفئ لظى النفوس المتعطشة إلى نور الله، فتنير القلب، وتشرح الصدر.
وأما الركن الثالث فهو إيتاء الزكاة، العبادة المالية التي فرضها الله على عباده، طُهرة لنفوسهم من البخل، ولصحائفهم من الخطايا، لذا قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [سورة التوبة : 103].
والركن الرابع هو صيام رمضان، ذلك الموسم العظيم، الذي يصقُل فيه المسلم إيمانه، ويجدد فيه العهد مع الله، وهو زاد إيماني قوي يشحذ الهمم لتواصل السير في درب الطاعة بعد رمضان حتى تصل إلى الله.
وختم الأركان بالحج إلى بيت الله الحرام الذي فرضه الله تعالى على المستطيع من المكلفين تزكية لنفوسهم، وتربية لهم على معاني العبودية والطاعة، فضلاً على أنه فرصة عظيمة لتكفير الخطايا والذنوب.
#الدرس_التاسع
#كتاب_الإيمان
👈 الوجيز في 👇
📓 شرح الحديث الصحيح 📓
【باب قول النبي ﷺ بُني الإسلام على خمس】
🔸 شرح الحديث التاسع 👇
(9)- عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "بُنِيَ الإِسْلامُ عَلى خَمْسٍ: شَهادَةِ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقامِ الصَّلاةِ، وَإِيتاءَ الزَّكاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ".
🔸 منزلة الحديث :
يقول الإمام النووي: "ثم إن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده وقد جمع أركانه".
👈مناسبة الحديث للباب :
يشير الحديث إلى أن دعائم وأسس وأركان الإسلام خمسة يقوم عليها.
🔸التعريف بالراوي :
عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عبد الرحمن المكي، وهو شقيق حفصة أم المؤمنين، أمهما: زينب بنت مظعون، أخت عثمان بن مظعون، أسلم بمكة وهو صغير وهاجر مع أبيه، ولم يشهد غزوة بدر ولا أحد لصغر سنه، وشارك في الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة.
وهو أحد العبادلة الأربعة مع عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير، غير أن الجوهري أثبت عبد الله بن مسعود وأخرجه، وهو من المكثرين في الرواية عن النبي ﷺ، حيث إنه روى رضي الله عنه ألف وستمائة وثلاثون حديثًا، اتفق الشيخان منها على مائة وسبعين، وانفرد البخاري بثمانين، ومسلم بإحدى وثلاثين. كان عالمًا زاهدًا عابدًا ورعًا. تُوفي بمكة سنة ثلاث وسبعين عن أربع وثمانين.
↩️ معاني المفردات :
قوله: "بُنِيَ الإِسْلامُ": أُسس الإسلام.
قوله: "شَهادَةِ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ": الشهادة هي الإخبار عن علم واعتقاد، والمعنى أن يقر العبد عن اعتقاد جازم أنه لا إله معبود بحق إلا الله سبحانه، ولا تتحقق الشهادة إلا بركنين: نفى عما سوى الله، وإثباتها له وحده لا شريك له.
قوله: "وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ": تقتضي الإقرار بأن محمدًا عبدُ لله ورسوله أُرسل لتبليغ دينه وهداية الخلق.
قوله: "وإقام الصلاة: أداؤها تامة بشروطها وأركانها والمحافظة على أوقاتها ومراعاة سننها وآدابها؛ لذا لم يقل أداء الصلاة؛ لأنه ليس مقصود الشارع فعلها فحسب، وإنما مقصوده الإتيان بها كاملة.
قوله: "وإيتاء الزكاة": أي إعطاء الزكاة ودفعها للأصناف التي حددها الشارع وفقًا لأحكامها ومقاديرها الشرعية. واشتقاقها من الزكاء أي النماء لأنها بركة للمال.
قوله: "وحج البيت": يعني القصد إلى بيت الله العتيق لأداء مناسك مخصوصة بنية خالصة لله تعالى.
قوله: "وصوم رمضان": الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية خالصة لله تعالى.
👈المعنى الإجمالي :
يشبه النبي ﷺ الإسلام بالبنيان الذي يقوم على أسس هذه الأسس هي الأركان الخمس التي يقوم عليها صرح الإسلام، فكما أن البنيان لا يثبت بدونها، فكذلك الإسلام، مع أن بقية خصال الإسلام تتمة للبنيان، فإذا فقد منها شيء نقص البنيان وهو قائم لا ينتقض بنقص ذلك بخلاف نقص هذه الدعائم الخمس، فإن الإسلام يزول بزوالها جميعا بغير إشكال، وكذلك يزول بفقد الشهادتين، فمن التزم بهذه الأركان الخمسة صار مسلمًا، ومن تركها جميعًا أو جحد شيئًا منها كفر.
فأول هذه الأركان وأعظمها كلمة التوحيد بشقيها، فهي المفتاح الذي يدخل به العبد إلى رياض الدين، ويكون به مستحقاً لجنات النعيم، فشقها الأول: "أشهد أن لا إله إلا الله" يعنى أن تشهد بلسانك مقرًا بقلبك بأنه لا يستحق أحد العبادة إلا الله، فلا نعبد إلا الله، ولا نرجو غيره، ولا نتوكل إلا عليه، وأما شقها الثاني: "أشهد أن محمدًا رسول الله" فتعني أنه لا متبوع بحق إلا رسول الله.
والنبي ﷺ جعل الشهادتين ركنًا واحدًا إشارة إلى أن العبادة لا تتم إلا بأمرين :
١) الأول: الإخلاص، وهو ما يحويه الشق الأول منها،
٢) والثاني: المتابعة، وهو مفهوم الشق الثاني.
الركن الثاني هو إقامة الصلاة المفروضة على الوجه الصحيح؛ لأنها صلة بين العبد وربه، ومناجاة لخالقه سبحانه، وهي الزاد الروحي الذي يطفئ لظى النفوس المتعطشة إلى نور الله، فتنير القلب، وتشرح الصدر.
وأما الركن الثالث فهو إيتاء الزكاة، العبادة المالية التي فرضها الله على عباده، طُهرة لنفوسهم من البخل، ولصحائفهم من الخطايا، لذا قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [سورة التوبة : 103].
والركن الرابع هو صيام رمضان، ذلك الموسم العظيم، الذي يصقُل فيه المسلم إيمانه، ويجدد فيه العهد مع الله، وهو زاد إيماني قوي يشحذ الهمم لتواصل السير في درب الطاعة بعد رمضان حتى تصل إلى الله.
وختم الأركان بالحج إلى بيت الله الحرام الذي فرضه الله تعالى على المستطيع من المكلفين تزكية لنفوسهم، وتربية لهم على معاني العبودية والطاعة، فضلاً على أنه فرصة عظيمة لتكفير الخطايا والذنوب.
👌 ما يؤخذ من الحديث :
1- أن الإسلام بناء محكم بأركانه وأسسه.
2- أهمية الصلاة في الإسلام ووجوب أدائها.
3- من ترك ركنًا واحدًا أو جحده فقد كفر.
4- وجوب إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا.
5- تنوع الدعائم الخمس لتشمل أعمال القلوب والجوارح، والأفعال والتروك.
⏪ فائدة متممة :
لماذا قدم الحج على الصوم؟
يحتمل أن ابن عمر سمعه من النبي ﷺ مرتين، مرة بتقديم الحج، ومرة بتقديم الصوم، فرواه أيضًا على الوجهين في وقتين، ويحتمل أن ابن عمر كان سمعه مرتين بالوجهين كما ذكرنا، ثم لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي رده فأنكره فهذان الاحتمالان هما المختاران في هذا.
- لمَ لم يذكر النبي ﷺ الجهاد في الحديث مع أنه من أفضل شرائع الإسلام؟
العلة في عدم ذكر الجهاد أمران:
الأول: أن الجهاد فرض كفاية عند الأكثر بخلاف سائر الأركان.
الثاني: أن الجهاد لا يستمر فعله إلى آخر الزمان بل ينقطع حين نزول عيسى -عليه السلام- بخلاف سائر الأركان.
قال الحافظ ابن حجر: "لم يذكر الإيمان بالملائكة وغيرهم مما في خبر جبريل؛ لأنه أراد بالشهادة تصديق الرسول في كل ما جاء به فيستلزم ذلك".
1- أن الإسلام بناء محكم بأركانه وأسسه.
2- أهمية الصلاة في الإسلام ووجوب أدائها.
3- من ترك ركنًا واحدًا أو جحده فقد كفر.
4- وجوب إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا.
5- تنوع الدعائم الخمس لتشمل أعمال القلوب والجوارح، والأفعال والتروك.
⏪ فائدة متممة :
لماذا قدم الحج على الصوم؟
يحتمل أن ابن عمر سمعه من النبي ﷺ مرتين، مرة بتقديم الحج، ومرة بتقديم الصوم، فرواه أيضًا على الوجهين في وقتين، ويحتمل أن ابن عمر كان سمعه مرتين بالوجهين كما ذكرنا، ثم لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي رده فأنكره فهذان الاحتمالان هما المختاران في هذا.
- لمَ لم يذكر النبي ﷺ الجهاد في الحديث مع أنه من أفضل شرائع الإسلام؟
العلة في عدم ذكر الجهاد أمران:
الأول: أن الجهاد فرض كفاية عند الأكثر بخلاف سائر الأركان.
الثاني: أن الجهاد لا يستمر فعله إلى آخر الزمان بل ينقطع حين نزول عيسى -عليه السلام- بخلاف سائر الأركان.
قال الحافظ ابن حجر: "لم يذكر الإيمان بالملائكة وغيرهم مما في خبر جبريل؛ لأنه أراد بالشهادة تصديق الرسول في كل ما جاء به فيستلزم ذلك".
#شرح_اللؤلؤ_والمرجان_فيما_اتفق_عليه_الشيخان
#الدرس_العاشر
#كتاب_الإيمان
👈 الوجيز في 👇
📓 شرح الحديث الصحيح 📓
【باب: الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه】
🔸 شرح الحديث العاشر 👇
(10)- عن ابْنِ عَبّاس قَالَ: "إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمّا أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَنِ الْقَوْمُ أَوْ مَنِ الْوَفْدُ؟ قَالُوا: رَبِيعَةَ، قَالَ: مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزايا وَلاَ نَدَامَى، فَقالُوا: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلاَّ في الشَّهْرِ الْحَرامِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذا الْحَيُّ مِنْ كُفّارِ مُضَرَ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنا، وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ، وَسَأَلُوهُ عَنِ الأَشْرِبَةِ، فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: أَمَرَهُمْ بِالإِيمانِ بِاللهِ وَحْدَهُ، قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الإِيمانُ بِاللهِ وَحْدَهُ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: شَهادَةُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقامُ الصَّلاةِ، وَإِيتاءُ الزَّكاةِ، وَصِيامُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمغنَمِ الْخُمُسَ، وَنَهاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنِ الْحَنْتَمِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالمُزَفَّتِ وَرُبَّما قَالَ: المُقَيَّرِ،
👈مناسبة الحديث للباب :
يأمر الحديث بجملةٍ من الأوامر، منها الإيمان بالله وحده لا شريك له وبرسوله ﷺ، ثم عرج على بعض شعائر وشرائع الدين، وأمرهم بدعوة قومهم إلى هذه الشرائع والتمسك بها.
🔸التعريف بالراوي :
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو العباس المدني، ابن عم رسول الله ﷺ، كان يقال له: الحبر والبحر، دعا له النبي ﷺ بالعلم والفهم والفقه في الدين، تُوفي سنة ثمانية وستين للهجرة.
↩️ معاني المفردات :
قوله: "خزايا": جمع خزيان وهو الذي أصابه خزي، وقيل: الذليل المهان.
قوله: "ولا ندامى": جمع ندمان بمعنى نادم.
قوله: "إلا في الشهر الحرام": وهي شهر ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب.
قوله: "بأمر فصلٍ": أي بعمل واضح بين لا إشكال فيه يفصل بين الحق والباطل.
قوله: "وسألوه عن الأشربة": هو من إطلاق المحل وإرادة الحال، أي ما في الحنتم ونحوه.
قوله: "الْحَنْتَمِ": جرار كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة، أعناقها على جنوبها.
قوله: "وَالدُّبَّاءِ": القرع.
قوله: "وَالنَّقِيرِ": أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر، ويلقى عليه الماء ليصير نبيذًا مسكرًا.
قوله: "وَالمُزَفَّتِ": هو الإناء الذي طُلى بالزفت وهو نوع من القار، ثم انتبذ فيه.
👈المعنى الإجمالي :
كانت وفادة عبد القيس سنة ثمان، حيث جاءوا إلى المدينة ودخلوا على النبي ﷺ في شهر رجب؛ لأن مُضر كانت تعظمه وتبالغ في احترامه، فطلبوا منه أن يُعلِمهم أهم شرائع الدين سواءً أكانت أوامر أم نواهي، فأمرهم النبي ﷺ بأربعة أوامر ونهاهم عن أربعة نواهي، فأمرهم أولاً بالإيمان بالله ورسوله من خلال تحقيق الشهادة، واتبع ذلك بأمره بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وختم الأوامر بإعطاء الخمس من المغنم، ونهاهم عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وهذه أوعية نهاهم عن نقع الشراب فيها؛ لأنه يسرع إليه الإسكار فيها. وأمرهم بحمل الدعوة إلى ما سمعوا من هذه الأوامر والنواهي وتبليغه من لم يسمعه من قومهم، فرب مبلغ أوعى من سامع.
👌 ما يؤخذ من الحديث :
1- أهمية وضرورة وفادة الرؤساء والأشراف إلى الأئمة عند الأمور المهمة.
2- توضيح ما يتوهم إشكاله على المستمع، حيث بين النبي ﷺ لوفد عبد القيس معنى الإيمان وفصله لهم.
3- النهي عن الانتباذ – النقع- في الأواني الأربع المذكورة في الحديث.
4- جواز مراجعة العالم على سبيل الاسترشاد.
#الدرس_العاشر
#كتاب_الإيمان
👈 الوجيز في 👇
📓 شرح الحديث الصحيح 📓
【باب: الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه】
🔸 شرح الحديث العاشر 👇
(10)- عن ابْنِ عَبّاس قَالَ: "إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمّا أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَنِ الْقَوْمُ أَوْ مَنِ الْوَفْدُ؟ قَالُوا: رَبِيعَةَ، قَالَ: مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزايا وَلاَ نَدَامَى، فَقالُوا: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلاَّ في الشَّهْرِ الْحَرامِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذا الْحَيُّ مِنْ كُفّارِ مُضَرَ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنا، وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ، وَسَأَلُوهُ عَنِ الأَشْرِبَةِ، فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: أَمَرَهُمْ بِالإِيمانِ بِاللهِ وَحْدَهُ، قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الإِيمانُ بِاللهِ وَحْدَهُ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: شَهادَةُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقامُ الصَّلاةِ، وَإِيتاءُ الزَّكاةِ، وَصِيامُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمغنَمِ الْخُمُسَ، وَنَهاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنِ الْحَنْتَمِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالمُزَفَّتِ وَرُبَّما قَالَ: المُقَيَّرِ،
وَقالَ: احْفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَراءَكُمْ".👈مناسبة الحديث للباب :
يأمر الحديث بجملةٍ من الأوامر، منها الإيمان بالله وحده لا شريك له وبرسوله ﷺ، ثم عرج على بعض شعائر وشرائع الدين، وأمرهم بدعوة قومهم إلى هذه الشرائع والتمسك بها.
🔸التعريف بالراوي :
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو العباس المدني، ابن عم رسول الله ﷺ، كان يقال له: الحبر والبحر، دعا له النبي ﷺ بالعلم والفهم والفقه في الدين، تُوفي سنة ثمانية وستين للهجرة.
↩️ معاني المفردات :
قوله: "خزايا": جمع خزيان وهو الذي أصابه خزي، وقيل: الذليل المهان.
قوله: "ولا ندامى": جمع ندمان بمعنى نادم.
قوله: "إلا في الشهر الحرام": وهي شهر ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب.
قوله: "بأمر فصلٍ": أي بعمل واضح بين لا إشكال فيه يفصل بين الحق والباطل.
قوله: "وسألوه عن الأشربة": هو من إطلاق المحل وإرادة الحال، أي ما في الحنتم ونحوه.
قوله: "الْحَنْتَمِ": جرار كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة، أعناقها على جنوبها.
قوله: "وَالدُّبَّاءِ": القرع.
قوله: "وَالنَّقِيرِ": أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر، ويلقى عليه الماء ليصير نبيذًا مسكرًا.
قوله: "وَالمُزَفَّتِ": هو الإناء الذي طُلى بالزفت وهو نوع من القار، ثم انتبذ فيه.
👈المعنى الإجمالي :
كانت وفادة عبد القيس سنة ثمان، حيث جاءوا إلى المدينة ودخلوا على النبي ﷺ في شهر رجب؛ لأن مُضر كانت تعظمه وتبالغ في احترامه، فطلبوا منه أن يُعلِمهم أهم شرائع الدين سواءً أكانت أوامر أم نواهي، فأمرهم النبي ﷺ بأربعة أوامر ونهاهم عن أربعة نواهي، فأمرهم أولاً بالإيمان بالله ورسوله من خلال تحقيق الشهادة، واتبع ذلك بأمره بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وختم الأوامر بإعطاء الخمس من المغنم، ونهاهم عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وهذه أوعية نهاهم عن نقع الشراب فيها؛ لأنه يسرع إليه الإسكار فيها. وأمرهم بحمل الدعوة إلى ما سمعوا من هذه الأوامر والنواهي وتبليغه من لم يسمعه من قومهم، فرب مبلغ أوعى من سامع.
👌 ما يؤخذ من الحديث :
1- أهمية وضرورة وفادة الرؤساء والأشراف إلى الأئمة عند الأمور المهمة.
2- توضيح ما يتوهم إشكاله على المستمع، حيث بين النبي ﷺ لوفد عبد القيس معنى الإيمان وفصله لهم.
3- النهي عن الانتباذ – النقع- في الأواني الأربع المذكورة في الحديث.
4- جواز مراجعة العالم على سبيل الاسترشاد.
رجل أقسم بأن لا يتزوج
حتى يشاور مائة رجل
فأقسم وقال لن أتزوج حتى أشاور
مائة رجل متزوج فشاور تسعة
وتسعين وبقي عليه واحد فعزم
أن أول من يلقاه في الغد يشاوره
ويعمل برأيه.
✍ فلما أصبح وخرج من منزله لقي مجنونًا
راكبًا قصبة فاغتم لذلك
(للعهد الذي قطعه على نفسه)
ولم يجد بدًا من الخروج
من عهده فتقدم إليه
👈فقال له المجنون:
احذر فرسي كي لا تضربك
👈فقال له الرجل: "احبس
فرسك حتى أسألك عن شيء"
فأوقفه
👈فقال: "إني قد عاهدت الله تعالى
أن أستشير مائة رجل متزوج
و أنت تمام المائة و كنت عاهدت نفسي
أن أشاور اليوم أول من يستقبلني ،
وأنت أول من استقبلني فإني
أُريد أن أتزوج فكيف أتزوج؟"🤔🤔
فقال له المجنون: "النساء ثلاثة:
♦واحدة لك
♦وواحدة عليك
♦وواحدة لا لك ولا عليك
ثم قال:- "احذر الفرس
كي لا تضربك ومضى"😅😅
فقال الرجل: "إني لم أسأله عن تفسيره"
؛فلحقه فقال: "
يا هذا احبس فرسك فحبسها"،😅😅
فدنا منه وقال:
"فسره لي فإني لم أفهم مقالتك"
فقال:
👈 "أما التي لك فهي المرأة البكر فقلبها
وحبها لك ولا تعرف أحدًا غيرك إن أحسنت
إليها قالت : هكذا الرجال
وإن أسأت إليها ، قالت : هكذا الرجال
👈وأما التي عليك ، فالثيب ذات الولد
تأخذ منك و تعطي ولدها و تأكل مالك
وتبكي على الزوج الأول
ُ👈وأما التي لا لك و لا عليك ،
فالثيب التي لا ولد لها إن أحسنت إليها
قالت هذا خير من ذاك ،
وإن أسأت إليها قالت :
ذاك خير من هذا
فإن كنت خيرا لها من الأول
فهي لك وإلا فعليك"
ثم مضى ؛ فلحقه الرجل "فقال له :
ويحك تكلمت بكلام الحكماء
وعملت عمل المجانين!!"
فقال:- "يا هذا إن قومي أرادوا أن يجعلوني
قاضيًا فأبيت فألحوا علي فجعلت
نفسي مجنونا حتى نجوت منهم"
حتى يشاور مائة رجل
فأقسم وقال لن أتزوج حتى أشاور
مائة رجل متزوج فشاور تسعة
وتسعين وبقي عليه واحد فعزم
أن أول من يلقاه في الغد يشاوره
ويعمل برأيه.
✍ فلما أصبح وخرج من منزله لقي مجنونًا
راكبًا قصبة فاغتم لذلك
(للعهد الذي قطعه على نفسه)
ولم يجد بدًا من الخروج
من عهده فتقدم إليه
👈فقال له المجنون:
احذر فرسي كي لا تضربك
👈فقال له الرجل: "احبس
فرسك حتى أسألك عن شيء"
فأوقفه
👈فقال: "إني قد عاهدت الله تعالى
أن أستشير مائة رجل متزوج
و أنت تمام المائة و كنت عاهدت نفسي
أن أشاور اليوم أول من يستقبلني ،
وأنت أول من استقبلني فإني
أُريد أن أتزوج فكيف أتزوج؟"🤔🤔
فقال له المجنون: "النساء ثلاثة:
♦واحدة لك
♦وواحدة عليك
♦وواحدة لا لك ولا عليك
ثم قال:- "احذر الفرس
كي لا تضربك ومضى"😅😅
فقال الرجل: "إني لم أسأله عن تفسيره"
؛فلحقه فقال: "
يا هذا احبس فرسك فحبسها"،😅😅
فدنا منه وقال:
"فسره لي فإني لم أفهم مقالتك"
فقال:
👈 "أما التي لك فهي المرأة البكر فقلبها
وحبها لك ولا تعرف أحدًا غيرك إن أحسنت
إليها قالت : هكذا الرجال
وإن أسأت إليها ، قالت : هكذا الرجال
👈وأما التي عليك ، فالثيب ذات الولد
تأخذ منك و تعطي ولدها و تأكل مالك
وتبكي على الزوج الأول
ُ👈وأما التي لا لك و لا عليك ،
فالثيب التي لا ولد لها إن أحسنت إليها
قالت هذا خير من ذاك ،
وإن أسأت إليها قالت :
ذاك خير من هذا
فإن كنت خيرا لها من الأول
فهي لك وإلا فعليك"
ثم مضى ؛ فلحقه الرجل "فقال له :
ويحك تكلمت بكلام الحكماء
وعملت عمل المجانين!!"
فقال:- "يا هذا إن قومي أرادوا أن يجعلوني
قاضيًا فأبيت فألحوا علي فجعلت
نفسي مجنونا حتى نجوت منهم"
#شرح_اللؤلؤ_والمرجان_فيما_اتفق_عليه_الشيخان
#الدرس_الحادي_عشر
#كتاب_الإيمان
👈 الوجيز في 👇
📓 شرح الحديث الصحيح 📓
【الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه】
🔸 شرح الحديث الحادي عشر 👇
(11)- عن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رضي الله عنه عَلى الْيَمنِ قَالَ: "إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلى قَوْمِ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبادَةُ اللهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَواتٍ في يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكاةً مِنْ أَمْوالِهِمْ وَتَردُّ عَلى فُقَرائِهِمْ، فَإِذا أَطَاعُوا بِها فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرائِم أَمْوالِ النَّاسِ".
👈مناسبة الحديث للباب :
يوضح الحديث عبادة الله وحده وهي من الإيمان، ثم يشير إلى أفضل شرائع الدين من صلاة وزكاة وغيرها، ويطالب معاذًا بالدعوة إلى ذلك.
🔸التعريف بالراوي :
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو العباس المدني، ابن عم رسول الله ﷺ، كان يقال له: الحبر والبحر، دعا له النبي ﷺ بالعلم والفهم والفقه في الدين، تُوفي سنة ثمانية وستين للهجرة.
↩️ معاني المفردات :
قوله: "توق": أي تجنب.
قوله: "كرائم أموالهم": أحبها إليهم، لما فيها من صفات حميدة، فهي أنفس أموالهم.
👈المعنى الإجمالي :
لما أرسل رسول الله ﷺ معاذًا إلى اليمن واليًا أو قاضيًا، زوده بوصية تحدد له معالم طريق الهداية والرشاد الواجب عليه اتباعها لينشر تعاليم الدين بين قوم أكثرهم من أهل الكتاب، ويفهم من وصية الرسول الله ﷺ التدرج معهم في الدعوة، ومعاملتهم بالتي هي أحسن؛ وعليه فليكن أول شيء تدعوهم إليه هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ﷺ، فإذا قالوها وأقروا بها، فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، وفصلها لهم وعرفهم كيفيتها، فإن هم قبلوا وأذعنوا وصلوا، فأعلمهم أن الله فرض على الأغنياء منهم زكاةً تجمع من أموالهم، وتفرق بين الفقراء، فإن استجابوا ورضخوا، فخذ منهم صدقاتهم ولا تلزمهم إخراج كرائم أموالهم ونفائسها، التي أحبوها واختصوها بفضل على غيرها، فلم يجعل الله مواساة الفقراء على حساب الإجحاف بالأغنياء.
👌 ما يؤخذ من الحديث :
1- وجوب النطق بالشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.
2- أن ولي الأمر يلزمه موعظة ولاته وأمرهم بالتقوى، ونهاهيم عن الظلم.
3- أنه ليس في المال حق واجب سوى الزكاة.
4- التحذير من أخذ كرائم أموال الناس وأنفسِها، بل يأخذ الوسط.
#الدرس_الحادي_عشر
#كتاب_الإيمان
👈 الوجيز في 👇
📓 شرح الحديث الصحيح 📓
【الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه】
🔸 شرح الحديث الحادي عشر 👇
(11)- عن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رضي الله عنه عَلى الْيَمنِ قَالَ: "إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلى قَوْمِ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبادَةُ اللهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَواتٍ في يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكاةً مِنْ أَمْوالِهِمْ وَتَردُّ عَلى فُقَرائِهِمْ، فَإِذا أَطَاعُوا بِها فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرائِم أَمْوالِ النَّاسِ".
👈مناسبة الحديث للباب :
يوضح الحديث عبادة الله وحده وهي من الإيمان، ثم يشير إلى أفضل شرائع الدين من صلاة وزكاة وغيرها، ويطالب معاذًا بالدعوة إلى ذلك.
🔸التعريف بالراوي :
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو العباس المدني، ابن عم رسول الله ﷺ، كان يقال له: الحبر والبحر، دعا له النبي ﷺ بالعلم والفهم والفقه في الدين، تُوفي سنة ثمانية وستين للهجرة.
↩️ معاني المفردات :
قوله: "توق": أي تجنب.
قوله: "كرائم أموالهم": أحبها إليهم، لما فيها من صفات حميدة، فهي أنفس أموالهم.
👈المعنى الإجمالي :
لما أرسل رسول الله ﷺ معاذًا إلى اليمن واليًا أو قاضيًا، زوده بوصية تحدد له معالم طريق الهداية والرشاد الواجب عليه اتباعها لينشر تعاليم الدين بين قوم أكثرهم من أهل الكتاب، ويفهم من وصية الرسول الله ﷺ التدرج معهم في الدعوة، ومعاملتهم بالتي هي أحسن؛ وعليه فليكن أول شيء تدعوهم إليه هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ﷺ، فإذا قالوها وأقروا بها، فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، وفصلها لهم وعرفهم كيفيتها، فإن هم قبلوا وأذعنوا وصلوا، فأعلمهم أن الله فرض على الأغنياء منهم زكاةً تجمع من أموالهم، وتفرق بين الفقراء، فإن استجابوا ورضخوا، فخذ منهم صدقاتهم ولا تلزمهم إخراج كرائم أموالهم ونفائسها، التي أحبوها واختصوها بفضل على غيرها، فلم يجعل الله مواساة الفقراء على حساب الإجحاف بالأغنياء.
👌 ما يؤخذ من الحديث :
1- وجوب النطق بالشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.
2- أن ولي الأمر يلزمه موعظة ولاته وأمرهم بالتقوى، ونهاهيم عن الظلم.
3- أنه ليس في المال حق واجب سوى الزكاة.
4- التحذير من أخذ كرائم أموال الناس وأنفسِها، بل يأخذ الوسط.
#شرح_اللؤلؤ_والمرجان_فيما_اتفق_عليه_الشيخان
#الدرس_الثاني_عشر
#كتاب_الإيمان
👈 الوجيز في 👇
📓 شرح الحديث الصحيح 📓
【الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه】
🔸 شرح الحديث الثاني عشر 👇
(12)- عن ابنِ عباسٍ أَنَّ النبي ﷺ بَعَثَ مُعاذًا إلى اليمن فقال: "اتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ فَإِنَّها لَيْسَ بَيْنَها وَبَيْنَ اللهِ حِجابٌ".
👈مناسبة الحديث للباب :
يأمر الحديث باتقاء دعوة المظلوم، وتحقيق هذا من باب الإيمان بالله ورسوله؛ لأنهما يأمران بالعدل ويحرمان الظلم.
🔸التعريف بالراوي :
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو العباس المدني، ابن عم رسول الله ﷺ، كان يقال له: الحبر والبحر، دعا له النبي ﷺ بالعلم والفهم والفقه في الدين، تُوفي سنة ثمانية وستين للهجرة.
↩️ معاني المفردات :
قوله: (حِجابٌ) الحاجز والمانع والساتر.
👈المعنى الإجمالي :
لما بعث النبي ﷺ معاذًا إلى اليمن وأمره بجمع الزكاة من الأغنياء ونهاه عن أخذ كرائم أموال الناس، وحذره من مغبة وعاقبة الظلم عامةً، وفي أخذ الصدقات خاصة، وحثه على التزام العدل دائمًا، وخوفه دعوة المظلوم؛ لأنها مستجابة، تُفتح لها أبواب السموات السبع، ولا يحول بينها وبين القبول حائل، وليس بينها وبين الله حجاب.
👌 ما يؤخذ من الحديث :
1 - أن دعوة المظلوم مستجابة عند الله.
2- ضرورة تحقيق العدل وتجنب الظلم بين الرعية.
3- توجيه النبي ﷺ الصحابة للخير وفعله.
#الدرس_الثاني_عشر
#كتاب_الإيمان
👈 الوجيز في 👇
📓 شرح الحديث الصحيح 📓
【الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه】
🔸 شرح الحديث الثاني عشر 👇
(12)- عن ابنِ عباسٍ أَنَّ النبي ﷺ بَعَثَ مُعاذًا إلى اليمن فقال: "اتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ فَإِنَّها لَيْسَ بَيْنَها وَبَيْنَ اللهِ حِجابٌ".
👈مناسبة الحديث للباب :
يأمر الحديث باتقاء دعوة المظلوم، وتحقيق هذا من باب الإيمان بالله ورسوله؛ لأنهما يأمران بالعدل ويحرمان الظلم.
🔸التعريف بالراوي :
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو العباس المدني، ابن عم رسول الله ﷺ، كان يقال له: الحبر والبحر، دعا له النبي ﷺ بالعلم والفهم والفقه في الدين، تُوفي سنة ثمانية وستين للهجرة.
↩️ معاني المفردات :
قوله: (حِجابٌ) الحاجز والمانع والساتر.
👈المعنى الإجمالي :
لما بعث النبي ﷺ معاذًا إلى اليمن وأمره بجمع الزكاة من الأغنياء ونهاه عن أخذ كرائم أموال الناس، وحذره من مغبة وعاقبة الظلم عامةً، وفي أخذ الصدقات خاصة، وحثه على التزام العدل دائمًا، وخوفه دعوة المظلوم؛ لأنها مستجابة، تُفتح لها أبواب السموات السبع، ولا يحول بينها وبين القبول حائل، وليس بينها وبين الله حجاب.
👌 ما يؤخذ من الحديث :
1 - أن دعوة المظلوم مستجابة عند الله.
2- ضرورة تحقيق العدل وتجنب الظلم بين الرعية.
3- توجيه النبي ﷺ الصحابة للخير وفعله.
#شرح_اللؤلؤ_والمرجان_فيما_اتفق_عليه_الشيخان
#الدرس_الثالث_عشر
#كتاب_الإيمان
👈 الوجيز في 👇
📓 شرح الحديث الصحيح 📓
【باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إِله إِلا الله محمد رسول الله】
🔸 شرح الحديث الثالث عشر 👇
(13)- عن أَبي بكر وعمر قال أبو هُرَيْرَةَ: لما تُوُفِّيَ رسول اللهِ ﷺ، وَكانَ أَبو بكرٍ رضي الله عنه، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَب، فَقالَ عمرُ رضي الله عنه: كَيْفَ تُقاتِلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتّى يَقُولوا لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قالَها فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسابُهُ عَلى اللهِ"، فَقالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لأُقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكاةِ، فَإِنَّ الزَّكاةَ حَقُّ الْمالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُوني عَناقًا كَانوا يُؤَدُّونَها إِلى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقاتَلْتُهُمْ عَلى مَنْعِها. قالَ عُمَر رضي الله عنه: فَواللهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ رضي الله عنه فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.
👈مناسبة الحديث للباب :
يوضح الحديث أن النطق بالشهادتين يعصم الدم والمال والعرض.
🔸التعريف بالراوي :
أبو هريرة الدوسي اليماني، عبد الرحمن بن صخر، أسلم في العام السابع، ولقب بأبي هريرة؛ لأنه كان يحمل هرًا في كمه، من أوعية العلم، وهو أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية عن رسول الله ﷺ للحديث، وتُوفي رضي الله عنه سنة سبع وخمسين للهجرة.
↩️ معاني المفردات :
قوله: "عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه": أي حرم ماله ونفسه بحق الإسلام، فأصبح ماله محفوظ ونفسه بحفظ الإسلام لهما.
قوله: "عناقًا": الأنثى من المعز.
👈المعنى الإجمالي :
سلك الناس بعد موت النبي طرقًا متعددة، فمنهم من ارتد وعاد إلى الجاهلية وأنكر الشرائع وترك الصلاة والزكاة وغيرها، ومنهم من ظل مسلمًا، لكنه فرق بين الصلاة والزكاة، فأقر بالصلاة وأنكر فرض الزكاة، ووجوب أدائها إلى الإمام.
فاستقبل أبو بكر الصديق خلافته بهذه الصورة المزعجة من التفرق، وشاءت إرادة الله أن يتحول أبو بكر من اللين والرقة إلى الشدة في الحق. وعليه فكان قراره الصائب بقتال من فرق بين الصلاة والزكاة، ولكنه ما كان له أن يمضي إلى ما رأى حتى يعرض الأمر على كبار الصحابة، عملاً بقوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ﴾ [سورة آل عمران: ١٥٩]، فقال له عمر بن الخطاب: كيف نقاتل من منع الزكاة وهو يشهد أن لا إله إلا الله؟ وقد قال رسول الله ﷺ: "أمرني ربي أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله فقد حقن مني دمه، وحفظ مني ماله وحسابه فيما وراء ذلك على الله؟". فقال له أبو بكر: أرأيت إذا لم يصلوا؟ فعندئذ سلم عمر بقتال من امتنع من الصلاة، وسكت وسكت الناس، فقال أبو بكر-وقد سكن قلبه إلى الرأي وشرح الله صدره لتنفيذه– قال بصوت الحكيم الحازم: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الصلاة حق النفس، والزكاة حق المال، فمن صلى عصم نفسه، ومن زكى عصم ماله، ومن لم يصل قُتل على ترك الصلاة، ومن لم يزك أخذت الزكاة منه قهرًا، فإن نصب لنا الحرب قاتلناه، والله لو منعوني حبلاً كانوا يعطونه لرسول الله ﷺ لقاتلتهم عليه.
👌ما يؤخذ من الحديث :
1- جواز مراجعة الأئمة والأكابر للوصول إلى الحق.
2- شجاعة أبي بكر، وتقدمه في العلم على غيره، وقد أجمع أهل الحق على أنه أفضل الأمة بعد رسول الله ﷺ.
3- الحث على قتال مانعي الصلاة أو الزكاة.
4- عدم تكفير أهل الشهادة من أهل البدع.
5- بيان واضح أن الإيمان قول وعمل، فالشهادة هي القول، والصلاة والزكاة وشرائع الإسلام هي العمل.
#الدرس_الثالث_عشر
#كتاب_الإيمان
👈 الوجيز في 👇
📓 شرح الحديث الصحيح 📓
【باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إِله إِلا الله محمد رسول الله】
🔸 شرح الحديث الثالث عشر 👇
(13)- عن أَبي بكر وعمر قال أبو هُرَيْرَةَ: لما تُوُفِّيَ رسول اللهِ ﷺ، وَكانَ أَبو بكرٍ رضي الله عنه، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَب، فَقالَ عمرُ رضي الله عنه: كَيْفَ تُقاتِلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتّى يَقُولوا لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قالَها فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسابُهُ عَلى اللهِ"، فَقالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لأُقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكاةِ، فَإِنَّ الزَّكاةَ حَقُّ الْمالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُوني عَناقًا كَانوا يُؤَدُّونَها إِلى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقاتَلْتُهُمْ عَلى مَنْعِها. قالَ عُمَر رضي الله عنه: فَواللهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ رضي الله عنه فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.
👈مناسبة الحديث للباب :
يوضح الحديث أن النطق بالشهادتين يعصم الدم والمال والعرض.
🔸التعريف بالراوي :
أبو هريرة الدوسي اليماني، عبد الرحمن بن صخر، أسلم في العام السابع، ولقب بأبي هريرة؛ لأنه كان يحمل هرًا في كمه، من أوعية العلم، وهو أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية عن رسول الله ﷺ للحديث، وتُوفي رضي الله عنه سنة سبع وخمسين للهجرة.
↩️ معاني المفردات :
قوله: "عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه": أي حرم ماله ونفسه بحق الإسلام، فأصبح ماله محفوظ ونفسه بحفظ الإسلام لهما.
قوله: "عناقًا": الأنثى من المعز.
👈المعنى الإجمالي :
سلك الناس بعد موت النبي طرقًا متعددة، فمنهم من ارتد وعاد إلى الجاهلية وأنكر الشرائع وترك الصلاة والزكاة وغيرها، ومنهم من ظل مسلمًا، لكنه فرق بين الصلاة والزكاة، فأقر بالصلاة وأنكر فرض الزكاة، ووجوب أدائها إلى الإمام.
فاستقبل أبو بكر الصديق خلافته بهذه الصورة المزعجة من التفرق، وشاءت إرادة الله أن يتحول أبو بكر من اللين والرقة إلى الشدة في الحق. وعليه فكان قراره الصائب بقتال من فرق بين الصلاة والزكاة، ولكنه ما كان له أن يمضي إلى ما رأى حتى يعرض الأمر على كبار الصحابة، عملاً بقوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ﴾ [سورة آل عمران: ١٥٩]، فقال له عمر بن الخطاب: كيف نقاتل من منع الزكاة وهو يشهد أن لا إله إلا الله؟ وقد قال رسول الله ﷺ: "أمرني ربي أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله فقد حقن مني دمه، وحفظ مني ماله وحسابه فيما وراء ذلك على الله؟". فقال له أبو بكر: أرأيت إذا لم يصلوا؟ فعندئذ سلم عمر بقتال من امتنع من الصلاة، وسكت وسكت الناس، فقال أبو بكر-وقد سكن قلبه إلى الرأي وشرح الله صدره لتنفيذه– قال بصوت الحكيم الحازم: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الصلاة حق النفس، والزكاة حق المال، فمن صلى عصم نفسه، ومن زكى عصم ماله، ومن لم يصل قُتل على ترك الصلاة، ومن لم يزك أخذت الزكاة منه قهرًا، فإن نصب لنا الحرب قاتلناه، والله لو منعوني حبلاً كانوا يعطونه لرسول الله ﷺ لقاتلتهم عليه.
👌ما يؤخذ من الحديث :
1- جواز مراجعة الأئمة والأكابر للوصول إلى الحق.
2- شجاعة أبي بكر، وتقدمه في العلم على غيره، وقد أجمع أهل الحق على أنه أفضل الأمة بعد رسول الله ﷺ.
3- الحث على قتال مانعي الصلاة أو الزكاة.
4- عدم تكفير أهل الشهادة من أهل البدع.
5- بيان واضح أن الإيمان قول وعمل، فالشهادة هي القول، والصلاة والزكاة وشرائع الإسلام هي العمل.